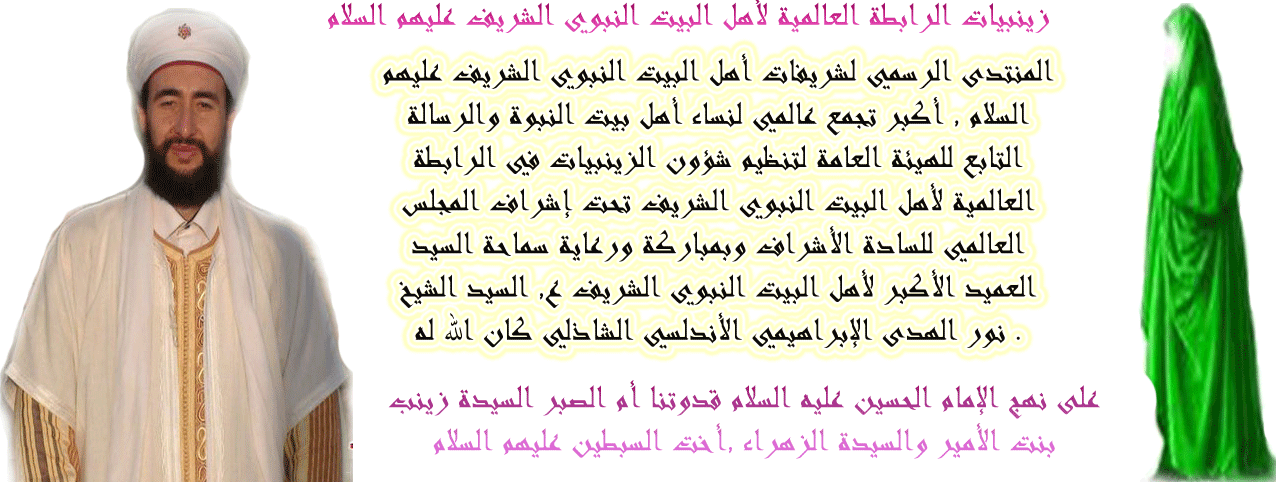في البحث عن علاقة التشيع بالتصوف، ينبغي أن نضع في الحسبان أن التصوف بحسب ما يفيدنا التاريخ لا يختص بمذهب دون غيره، فالشيعة منهم متصوفة ومنهم غير متصوفة، والمتصوفة فيهم
الشيعة وفيهم غير الشيعة. وإذا كان المتصوفة من الشيعة هم قلة نسبة إلى المتصوفة السنة بحسب نقل المستشرق نيكلسون [1]، فذلك يرجع إلى اعتبارات تاريخية خاصة تحكمت بذاكرة التاريخ، واستحوذت على دلالات المصطلح المتعاقبة لمفهومي التشيع [2] والتصوف سلبا وإيجابا. ومهما يكن، ليس التصوف مذهبا من مذاهب السنة، كما ليس هو فرقة مستقلة عن سائر الفرق الإسلامية.
التصوف في نطاق التوظيف
تبدأ مرحلة التصوف بحسب الدراسات المتداولة عموما بحدود القرن الثاني الهجري، وتحديدا مع الحسن البصري بصورة خاصة، وهي تتجاهل في ذلك “صوفية” المرحلة الإسلامية المبكرة، بحجة أن لقب الصحابي غلب على لقب الصوفي أو بغير ذلك. ففي مرحلة ظهور الدعوة الإسلامية والتي تمتد خلال القرن الأول الهجري، كان التصوف مفعما بالمعنويات، مصطبغا بمنحى باطني عميق، مشتملا على الجهاد في سبيل الله، وكل ما يحمله العرفان من قيم ودلالات راقية. وأشخاص هذه المرحلة هم النبي (ص) نفسه، والأئمة (ع)، وجملة من الصحابة والخواص، من قبيل أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد وكثير من الشخصيات العرفانية المبكرة والتي لم تتحدث المصادر عنها كثيرا، من أمثال مالك بن حارثة. وتمتد هذه المرحلة المهمَلة مع رشيد الهجري وأويس القرني وكميل بن زياد وبرير وحبيب بن مظاهر وأمثالهم، وقد تضمنت المصادر الروائية إشارات عن هؤلاء، كما في قصة همام الذي قضى نتيجة تأثره بوصف المتقين في خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، ومنهم الربيع بن خثيم خال همام وأحد الزهاد الثمانية الذي صعق ووقع مغشيا عليه عندما سمع قوله تعالى: (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا) فرقان / 12، ومنهم أويس القرني الذي شهق شهقة غاشية عندما سمع قوله تعالى: (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) الدخان / 40، وأمثال هؤلاء ممن عاشوا الروحانية الإسلامية العالية بما تلقوه من مولاهم علي بن أبي طالب (ع) كثيرون. وإذا تجاوزنا المراحل المتعاقبة لنمو التصوف بعيدا عن منازعات السلطة، وإن كان كثير من المتصوفة قد نالوا حظوظهم التي لا يحسدون عليها بفعل الاحتكاك بالسلطة ولو عرضا. فقد اكتسب التصوف طابعه المذهبي “السني” بصورته الكاملة في مرحلة الانتظام في الطرق والخوانق، وذلك بفعل عدة عوامل وأسباب سلطوية _ مذهبية تعود إلى زمن الأيوبيين والمماليك تحديدا. ومن هنا يذكر التاريخ أن الطرق الصوفية انتقلت من بلاد المغرب العربي إلى مصر وبلاد الشام ثم إلى العراق وفارس، وذلك بتشجيع من السلطان الأيوبي نفسه، فكانت للصوفية خانقاه “سعيد السعداء” التي دعمها صلاح الدين في القاهرة وكانت أول خانقاه أسست في مصر. يقول سميح عاطف الزين: “ومع اشتداد تيار الهجرة إلى مصر وفد إليها جماعة من هؤلاء الأعلام في طليعتهم عبد الرحيم القنائي وأبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي وابن عطاء الله السكندري وأحمد البدوي وغيرهم”. ونشأت أول طريقة صوفية في مصر في مدينة “قنا” أنشأها الشيخ عبد الرحيم القنائي الذي توفي بها عام (592 هـ). وخلال العهدين الأيوبي والمملوكي برزت الطرق الصوفية الأساسية، وأهمها: الشاذلية، القادرية، القلندرية، العيسوية، المولوية، النقشبندية. وكانت غاية السلطة المملوكية التي كانت مؤلفة من قادة عسكريين لا يمتون بصلة إلى عائلة الرسول (ص)، أن يفرضوا احترامهم على الناس فحصروا عددا كبيرا من المسلمين في أعمال وممارسات بعيدة عن السياسة وأعمال الدولة، ليأمنوا بذلك انتفاضات دينية أو معارضات سياسية تؤثر على حكمهم. ويقال أن عدد المتصوفة في عهد المماليك زاد على المائة ألف متصوف كانوا قابعين في خوانقهم بعيدين عن السياسة والسلطة الحاكمة. واعتنق المماليك فكرة “التصوف مقبرة السياسة”. وذكر الدكتور عبد المنعم الحفني في كتابه (الموسوعة الصوفية) اسم مائة وإحدى وعشرين طريقة صوفية معظمها فروع عن الطرق الأساسية المذكورة، ومهما يكن فقد كان على رأس الأهداف المنشودة للترويج لمثل هذا التوجه هو إجراء غسل دماغ جماعي طال الأمة بأسرها لغايات متعلقة بالسلطة وان كان ذلك كله قد تم تحت ستار الدعوة إلى الدين والمذهب. وينبغي الإشارة إلى أن معظم الذين كتبوا في التصوف اعتبروا أن القرن التاسع الهجري تقريبا هو المرحلة الأخيرة من مراحل التصوف، فأهملوا بذلك المنحى العرفاني المتأخر والمتمثل بما أنتجته جهود الكثير من عرفاء مدرسة أصفهان وما تلاها. ومن الجدير بالذكر أن التصوف المذهبي في النطاق “الشيعي” ازدهر إبان الحكم الصفوي في إيران والذي اعتمد مذهب التشيع مذهبا رسميا للدولة، فقد شجعت الدولة الصفوية من انتشار هذا التيار، وان كان ذلك – بحسب المحللين في التاريخ – بدافع من العوامل التاريخية والإجتماعية والمذهبية. ومهما يكن فقد عملت هذه الدولة الفتية على جمع وحماية رجال الفكر وبخاصة أصحاب المنحى العرفاني منهم. وصادف المذهب الباطني في إيران تربة خصبة صالحة للنمو والإزدهار، ثم ما لبث أن أصابه الضمور والذبول أمام سلطان الفقه المتمادي آنذاك. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التصوف لم يكن ليحظى بالرضا غالبا سواء على صعيد التشيع الرسمي أو التسنن كذلك، كما يتضح أن القطيعة الطارئة بين التشيع والتصوف يعود سببها إلى التوظيف السلطوي للتصوف في مناهضة التشيع ولاسباب سياسية غالبا، فالطرق الصوفية كانت قد انتشرت بفعل الترويج الدعائي المذهبي الذي افتعله السلطان لخدمة أهدافه، ومذاك كان التصوف يدعم مذهبا لصالح آخر [3]. وأدى بعد ذلك إلى حركة ارتدادية تجاه الشريعة تدعو إلى نبذ الظاهر واستباحة المحرمات، وعلى هذا الأساس اعتبر التشيع موقفا مؤسسا من التصوف عامة يمكن تلخيصه بأنه موقف أهل الشريعة التقليدي.
إشكالية الوصل
وفي مجال ترسيم العلاقة بين التشيع والتصوف، فإن وجهة النظر إلى التصوف كانت تتحكم بطبيعة العلاقة المرسومة بينهما، وحيث تكون النظرة الى التصوف سوداوية، فإنه يجري ربط التصوف بالتشيع ربطا مفتعلا يقوم على مجرد التشابه ولو في بعض الوجوه العابرة (الإمامة والقطبية، العصمة والحفظ، المهدوية، زيارة الأولياء..). نعم في المجال الذي لا تكون النظرة إلى التصوف سوداوية، يستبعد التشيع تماما عن مجالات البحث والمقارنة. وعليه، فقد عمدت الدراسات الأكثر تداولا إلى تصوير الحدث العلائقي بين التشيع والتصوف تصويرا مشبوها في الغالب،، فأساءت إلى المعايير العلمية والموضوعية في الوصل والربط على نحو كان الهدف موجّها منذ البدء الوجهة التي يرتئيها الكاتب والتي كثيرا ما كان يعتورها التبسيط في الطرح والسطحية في المعالجة والتشوّش في الرؤية بفعل المواقف الشخصية والدوافع الاستنسابية والتي كانت تتشكل على أساس خلفية الكاتب الذهنية وتظهر في حكمه على الأشياء بصورة مسبّقة. وهكذا يربط السراج الطوسي في كتابه “اللمع” علم الصوفية وخُلقهم بالإمام علي (ع)، متجاوزا في ذلك حقيقة أن الأئمة الإثني عشر – دون غيرهم – اختصوا بعلم لدني ناشئ من اختصاصهم بمهام خلافة الرسول (ص) في قيادة المسلمين دينيا ودنيويا، بينما يحصل المتصوفة علومهم بالكسب كسائر الناس، وهم بالدرجة الأولى أصحاب أحوال لا أصحاب علوم، والعلم اللدني الذي تزعمه الصوفية لأقطابها لا يضبطه عدد خاص. ومن جهة ثانية يربط عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته مفهوم القطب عند المتصوفة بمسألة الإمامة عند الشيعة، متجاوزا في ذلك المساحة التي تفصل بينهما ؛ فإن القطب عند الصوفية يتربع على مملكة باطنية اصطنعها المتصوفة، بينما الإمام عند الشيعة يقوم بتولي ورعاية أمور المسلمين السياسية والدينية كما كان للرسول (ص). ومن جهة ثالثة استغل أحمد أمين في كتابه “ضحى الإسلام” فكرة المهدوية موظفا لها في خدمة الفكر الصوفي، مع ما في ذلك من القفز فوق الحقائق والوقائع، لا اقل فان المهدوية ليست من اختصاص الشيعة بل هي عقيدة إسلامية يؤمن بها جميع المسلمين بلا تفاوت في اصل المعتقد. ومن جهة رابعة ذهب كامل مصطفى الشيبي في كتابه “الصلة بين التصوف والتشيع” إلى ربط التصوف بفكرة العصمة والشفاعة وزيارة قبور الأولياء عند الشيعة. متجاهلا حقيقة أن العصمة عند الشيعة وإن كان قد يقابلها الحفظ عند الصوفية، إلا أن أكثر الصوفية لا يعتقدون بالحفظ ولا بالقطب وإنما يكتفون بإتباع الشيوخ، فلا وجه لإطلاق القول بان الصوفية متأثرة بفكرة العصمة عند الشيعة. وهناك ما لا يحصى من التطفلات في هذا المجال، كدعوى المولوي سلامت علي الذي لما لم يتمكن من نفي دلالة حديث الغدير على الإمامة، حمل الإمامة المستفادة من هذا الحديث الشريف على إمامة التصوف، فقال ما تعريبه: ” لا شك عند أهل السنة في إمامة أمير المؤمنين وان ذلك عين الإيمان، لكن ينبغي أن يكون مفاد أحاديث الغدير الإمامة المعنوية لا الخلافة، وهذا المعنى هو المستفاد من كلام أهل السنة وعلماء الصوفية، ومن هنا كانت بيعة جميع السلاسل منتهية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن طريقه تتصل برسول الثقلين ” [4]. ومن الواضح أن هذا التأويل لا يمكن الركون إليه، وإلا فلو جاز تأويل حديث الغدير وحمله على الإمامة الباطنية لجاز تأويل ما يدل على نبوة رسول الإسلام وحملها على الرفعة – وهو المعنى اللغوي للفظ – وصرفها عما يفيد المعنى الاصطلاحي للنبوة والوحي، ومن الواضح بطلان ذلك. مضافا إلى أن الإمامة ظل الرسالة، ومبناها على الإظهار لا الإخفاء [5]. وعليه فهذه المحاولات وغيرها تستند في الربط بين التصوف والتشيع على مجرد التشابه العابر، وذلك من خلال العبث بالمفاهيم الخاصة بعيدا عن المعايير العلمية الموضوعية، إذ مجرد التشابه لا يجعل أحد الفريقين مرتبطا بالآخر هذا النحو من الارتباط، وإلا فلا تكاد تخلو المذاهب الإسلامية من تشابه مع غيرها من مذاهب الأديان الأخرى وذلك في تنويعاتها الكبرى وفي بعض الوجوه، ولكن لا ينبغي أن يفسّر ذلك بوجود ارتباط وتأثر فيما بينها بالضرورة كما لا يخفى على المنصف اللبيب. ومهما يكن، فإن هذه القنوات المفتعلة للربط المبتذل لا تنم عن ذكاء ونفاذ كبيرين في ذهنية أصحابها، تماما كما هو حال ما توحي به المعطيات الأكثر حداثة في هذا المجال والتي سيتم التعرض لها في مقالة لاحقة بإذنه تعالى، وإنما اكتفيت هنا بترديد هذه المقولات التقليدية من باب الإشارة والتمهيد لا أكثر.
إشكالية الفصل
وكما وقع اللغط على مستوى الربط بين التصوف والتشيع، وقع أيضا على مستوى الفصل بينهما، فقد ذهب البعض إلى الفصل بين التشيع والتصوف على أساس موقف الأئمة (ع) الرافض للتصوف، مستندا في ذلك إلى الرصيد الكبير من بياناتهم (ع) التي يتجلى فيها موقف الرفض للتصوف بوضوح، وهذه الروايات عديدة، نذكر منها على سبيل المثال: ما روي عن الإمام الصادق (ع) حين سئل عن قوم ظهروا في زمانه يقال لهم (صوفية) قال (ع): “إنهم أعداؤنا، فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم، وسيكون أقوام يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم وأقوالهم، ألا فمن مال إليهم فليس منا، وأنا منه براء ومن تنكر لهم ورد عليهم، كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله” [6]. وما روي عن الإمام أبي الحسن العسكري (ع) أنه قال: “سئل أبو عبد الله الصادق (ع) عن حال أبي هشام الكوفي، فقال: انه كان فاسد العقيدة جدا، وهو الذي ابتدع مذهبا يقال له: التصوف، وجعله مقرا لعقيدته الخبيثة، وأكثر الملاحدة، وجنة لعقائدهم الباطلة”. وأبو هشام هو أول من عرف بلقب الصوفي [7]. وما روي عن الإمام الرضا (ع) قوله: “لا يقول بالتصوف أحد إلا لخدعة أو ضلالة وحماقة” [8]. وما روي أن قوما من المتصوفة دخلوا بخراسان على علي بن موسى الرضا (ع) فقالوا له: إن أمير المؤمنين (ع) فكّر فيما ولاه الله من الأمور، فرآكم أهل بمن أولى أن تؤموا الناس، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولى الناس بالناس، فرأى أن يرد هذا الأمر إليك، والإمامة تحتاج إلى من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويركب الحمار ويعود المريض. فقال لهم الرضا (ع): إن يوسف كان نبيا يلبس أقبية الديباج المزردة بالذهب، ويجلس على متكآت آل فرعون ويحكم، إنما يراد من الإمام قسطه وعدله، إذا قال صدق وإذا حكم عدل وإذا وعد صدق. إن الله لم يحرم لبوسا ولا مطعما، ثم قرأ: (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق)” [9]. وما روي من أن الإمام علي الهادي (ع) كان جالسا في مسجد رسول الله (ص) إذ أتاه جماعة من أصحابه ثم دخل جماعة من الصوفية وجلسوا في جانب المسجد مستديرين واخذوا بالتهليل فقال الإمام الهادي (ع): “لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخداعين فإنهم الشياطين، فخربوا قواعد الدين يتزهدون لراحة الأجسام ويتهجدون لتصيد الأنعام ويتجوعون عمرا حتى يرخوا الأركان حمرا، لا يهللون إلا لغرور الناس، ولا يقللون الغذاء إلا لمنع العساس واختلاس قلب الدفناس (الغبي) ويتكلمون بإملائهم في الحب ويطرحونهم بإدلائهم في الجب، أورادهم الرقص والتصدية، وأذكارهم الترنم والتغنية، فلا يتبعهم إلا السفهاء، ولا يعتقد بهم إلا الحمقاء، فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حيا أو ميتا فكأنما أعان (يزيد ومعاوية وأبا سفيان). فقال له رجل من أصحابه: وان كان معترفا بحقوقكم، فنظر إليه شبه المغضب وقال: دع ذا عنك، من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا، أما تدري أنهم أخس طوائف الأمة، أولئك الذين يجهدون في إطفاء نور الله، والله يتم نوره ولو كره الكافرون” [10]. وما روي عن الإمام الحسن العسكري (ع) انه قال لأبي هشام الجعفي: يا أبا هشام، سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة، قلوبهم مظلمة منكدرة، السنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر، والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جائرون علماؤهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنياؤهم يسرقون زاد فقرائهم، وأصاغرهم يعتدون على الكبراء، كل جاهل عندهم خبير، وكل محيل عندهم فقير، لا يميزون بين المخلص والمرتاب، ولا يعرفون الضأن من الذئاب، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، وايم الله: إنهم من أهل العدوان والتحرف، يبالغون في حب مخالفينا، ويضلون شيعتنا وموالينا” [11]. بل نقل عن رسول الله (ص) في وصيته لأبي ذر الغفاري أنه قال: “يا أبا ذر يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أن لهم الفضل بذلك على غيرهم، أولئك يلعنهم ملائكة السماوات والأرض” [12]. وهذه الروايات لا تتم من جهة الدلالة على المقصود بتوجيه الدلالة وجهة نبذ التصوف بالمطلق، أما إذا كان المراد منها نبذ السلوكيات المنحرفة في عالم التصوف والتي كانت سائدة زمن الأئمة (ع) وما بعدهم، فإنها حينئذ تكون واردة على نحو القضية الخارجية لا الحقيقية كما قد يستفاد من القرائن المحتفة بها. ونتلمس ذلك بوضوح في كلمات الإمام الصادق (ع) التي تنبض بصراحة تامة في مناهضة التصوف، وذلك نظرا “لطبيعة التطور الذي حدث للتصوف في ذلك العصر حيث تحول على عهده إلى فئة اجتماعية بل ومذهب فلسفي” [13]. وإذا انتقلنا من الناحية الروائية إلى الناحية التاريخية، نجد كثرة وافرة من كتب ومصنفات شيعية كتبت بعنوان “الرد على الصوفية” ونحو ذلك. وهي لا تبتعد عن التوجيه المتقدم، وإلا فلو تأملنا في المرحلة التاريخية الأولى لظهور التصوف نجد أن التصوف في نشأته قد تمثل بالنبي (ص) والأئمة (ع) وبالشخصيات الشيعية من الطراز الأول. وقد تقدم أن التشيع وقف بوجه التصوف الآخذ في الانحراف بفعل الاستخدام السلطوي له، لا مطلق التصوف.
بين التصوف والعرفان
يصر الكثيرون على إجراء فصل بين التصوف والعرفان، بحيث ترجع التفرقة إلى أسباب خارجية أو داخلية، وجملة الأقوال في المسألة هي إرجاع الفرق بينهما تارة إلى أسباب قومية، كالفارق بين أهل إيران وغيرهم. وتارة أخرى إلى أسباب مذهبية، كالفارق بين الشيعة والسنة تارة أخرى. وثالثة على أساس أن العرفان يختص بالناحية الفكرية، بينما التصوف يختص بالناحية الاجتماعية. ورابعة على أساس أن العرفان نظري قائم على الفكر والكشف الإشراقي، أما التصوف فعملي قائم على التصفية وإتباع الطريقة. وخامسة على أساس أن الصوفي هو السالك الذي يعمل في نطاق التخلية والتحلية، والعارف هو الواصل الذي تجاوز الطريقة إلى الحقيقة، فالعرفان هنا ليس نفيا للتصوف وإنما هو استكمال. وسادسة على أساس أن العرفان يشكل تصويبا ونقدا لمسار تاريخي وعقيدي وسلوكي أصيبت به الحركة الصوفية. ويتضح – سيما على الرأي الأخير – أن التصوف والعرفان يقتبسان من مصدر واحد، والعرفان ليس علما مستقلا عن التصوف ومختلفا عنه، بل هو محاولة للعودة بالتصوف إلى أصالته التي تتمثل بالصفاء الفطري والنقاء الوجداني كما دعت إليه الأديان. ويعود السبب في تغيير الاسم من التصوف إلى العرفان إلى التداعيات السياسية والفكرية التي حصلت في العهد الصفوي، فكان من شأن هذه التداعيات أن أزرت بالمتصوفة وأفكارهم التي لازمها الابتذال على جميع الصعد وبالأخص التحلل من قيود الشريعة.
منقول